ساعة "التغير المناخي" تدق.. تُرى هل نحن جاهزون؟
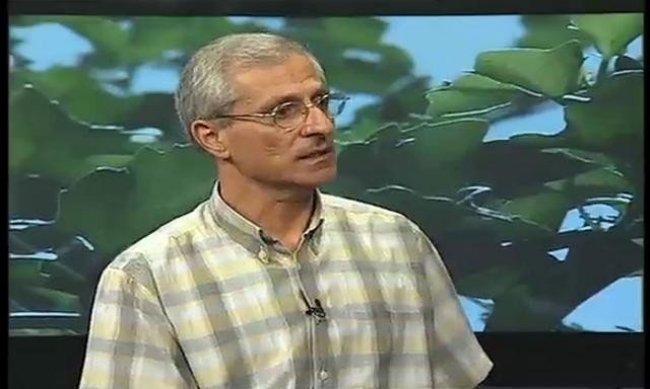
الكاتب: جورج كرزم
أفاد تقرير دولي أخير بأن مقدار الارتفاع في غازات الغلاف الجوي خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق؛ إذ بلغ تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ذروته، رغم الإغلاقات التي فرضتها دول العالم لوقف جائحة كورونا، وذلك بحسب بيانات أصدرتها منظمة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.
تقديرات المنظمة تقول بأنه رغم حدوث انخفاض في حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال العام الماضي، بنسبة تراوحت بين 4.2٪ إلى 7.5٪، بسبب شلل حركة النقل والأنشطة الأخرى، إلا أن تأثير الانخفاض على التراكم المستمر لغازات الدفيئة بسبب النشاط البشري ضئيل، بل أقل من التغير الطبيعي الذي يحدث سنويًا.
كما أظهر التقرير بأن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في سبتمبر الماضي بمحطة Mauna Loa (مونا لوا) في هواي، والتي تستخدم كمعيار لقياس تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، بلغ 411.3 جزيئًا لكل مليون، مقارنة بـ 408.5 في سبتمبر 2019. كما سُجلّت زيادة متساوية تقريبًا في محطة Cape Grim(كيب غريم) بشمال غرب تسمانيا في أستراليا، وتحديدًا من 408.6 جسيمًا لكل مليون في عام 2019 إلى 410.8 في عام 2020.
في العام الماضي، سُجل ارتفاع حاد في متوسط ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مقارنة بمتوسط الارتفاع في العقد السابق. وتظهر البيانات أن التدابير المتخذة للحد من الانبعاثات، لا تزال بعيدة كل البعد عن المطلوب لمنع أشد الأضرار المدمرة الناجمة عن أزمة المناخ.
وفقًا للحسابات العلمية، بحلول عام 2030 يجب خفض حجم الانبعاثات إلى النصف، بحيث تكون هناك فرصة معقولة لمنع ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بأكثر من درجة ونصف مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة؛ إذ أن الاحترار الأكبر من ذلك يمكن أن يتسبب في موجات حرارة وجفاف وفيضانات، ما قد يؤدي إلى انزلاق مئات ملايين الناس إلى براثن الفقر.
دول مختلفة تعهدت بخفض مستويات انبعاثاتها قبل قمة الأمم المتحدة التي كان يفترض عقدها في غلاسكو (اسكتلندا) في نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها لمدة عام بسبب الجائحة.
الانخفاض في الانبعاثات بسبب إغلاقات "كورونا" ليس سوى انحراف طفيف في المنحنى طويل الأمد، وما يجب حدوثه هو تسطيح المنحنى على المدى الطويل. وللتذكير، في عام 2015 تجاوزنا الحد العالمي السنوي البالغ 400 جسيم لكل مليون، وفي غضون أربع سنوات فقط (2019) تجاوزنا حد ألـ 410، ما يعد زيادة غير مسبوقة. ومن المعروف أن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لبضعة قرون. المرة الأخيرة التي سُجِّلَ فيها تركيز مشابه على الأرض كان قبل ثلاثة إلى خمسة ملايين سنة. حينئذ كانت درجة الحرارة أعلى بدرجتين إلى ثلاث درجات، وكان مستوى سطح البحر أعلى بمقدار مترين إلى ثلاثة أمتار مما هو عليه اليوم. لكن، آنذاك، لم يقطن على سطح الأرض أكثر من سبعة مليارات إنسان.
كما وجد التقرير أن مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حاليًا أعلى مما كان عليه عام 1750 (في حقبة ما قبل الثورة الصناعية) بمقدار 50٪، وثاني أكسيد الكربون يمتص نحو ثلثي إجمالي الحرارة المنبعثة من سطح الأرض، والتي، بشكل عام، تحتجزها غازات الاحتباس الحراري؛ ومنذ عام 1990 سجلت مستويات الحرارة هذه زيادة مقدارها 45٪.
غاز دفيئة رئيسي آخر هو الميثان الذي ينبعث من قطعان الماشية وحقول الأرز وأثناء إنتاج الوقود الهيدروكربوني. هذا الغاز مسؤول عن احتباس حوالي 17٪ من الحرارة التي تحتجزها غازات الدفيئة. حاليا، تركيز غاز الميثان في الغلاف الجوي أعلى بمرتين ونصف مما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة.
ومن بين غازات الدفيئة المهمة الأخرى أكسيد النتروز (N2O) المنبعث بسبب الإفراط في استخدام الأسمدة الزراعية الكيميائية وبخاصة النيتروجينية، وأثناء حرائق الغابات. تركيز هذا الغاز الآن أعلى بمقدار 23٪ مما كان عليه عام 1750.
البيانات المتعلقة بغازات الاحتباس الحراري يتم جمعها من قبل الشبكة العالمية لمراقبة الغلاف الجوي، والتي تدير محطات قياس في القطب الشمالي وقمم الجبال والجزر الاستوائية؛ وتستمر هذه المحطات في العمل، رغم قيود جائحة كورونا التي تؤثر على تواتر الوصول إليها واستبدال طاقم العاملين الذين يقيم العديد منهم في أماكن معزولة بظروف مناخية قاسية.
وكما أكدنا أكثر من مرة في مجلة آفاق البيئة والتنمية، يتعين على العالم بشكل عام والدول الصناعية بشكل خاص، أن يغير جذريًا البنية التحتية للصناعة والطاقة والنقل؛ فهذا الأمر ممكن تقنيًا واقتصاديًا؛ علمًا أن تأثير تغييرات من هذا النوع على حياتنا اليومية سيكون هامشيًا.
مجلة Nature نشرت مؤخرًا بحثًا قدم بيانات حديثة حول انبعاثات غاز أكسيد النتروز الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث قوة تأثيره في عملية الاحترار العالمي، بعد ثاني أكسيد الكربون والميثان، ووجد البحث بأنه بين عامي 2007 و2016، حدثت زيادة مقدارها 30٪ في انبعاثات أكسيد النتروز بسبب النشاط البشري، وذلك أكثر بكثير مما ورد في تقديرات سابقة. ووفقًا للبحث، فإن أحد المصادر الرئيسية لهذه الزيادة هو النمو الاقتصادي المتسارع للبرازيل والصين والهند.
تحول استراتيجي نحو الطاقات المتجددة
عشية اندلاع أزمة كورونا، بدا أن سوق الطاقة العالمي يتجه نحو تحول ثوري. إثر سنوات من النضال السياسي-البيئي، دفع انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة والتحسينات التكنولوجية والوعي العام المتزايد بأزمة المناخ- دفع العديد من البلدان إلى الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الدول الأكثر تقدمًا، مثل الدول الاسكندنافية وألمانيا، تمكنت فعليا من توليد عشرات في المائة من استهلاكها للكهرباء من مصادر غير ملوثة.
وفي هذا السياق، تمثلت المشكلة الأولى التي سببتها جائحة كورونا فيتوقف الإنتاج بالصين؛ إذ أن الصين التي تفشت فيها الجائحة تنتج أكثر من 90٪ من إجمالي الخلايا الشمسية في العالم، وبالتالي، أدى توقف الإنتاج والصادرات بسبب الإغلاق إلى تعطيل العديد من المشاريع.
علاوة على ذلك، يعتقد العديد من النشطاء البيئيين بأن الاهتمام العالمي بالقضايا المناخية كاد أن يختفي خلال جائحة كورونا.
وإذ بدا قبل الأزمة بأن الحركة البيئية بدأت تسجل نجاحات في إيصال رسائلها، إلا أن ثمة شعور بحدوث تغير كبير طرأ على جدول الأعمال العام فيما يتعلق باهتمام الحكومات بقضية أزمة المناخ.
لكن، القلق الأكبر المسيطر على الشركات الخضراء والنشطاء في جميع أنحاء العالم هو أن الأزمة ستدفع الحكومات إلى تقليل أو وقف استثمارها في الطاقات المتجددة، كما أن الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع ستنخفض بسبب الاضطرابات الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، قد يؤدي انهيار أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، إلى تأخير انتشار المركبات الكهربائية، لأن قيادة سيارة تعمل بالبنزين ستكون رخيصة للغاية، على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
وفي تقديرنا، أنه لضمان تعافي اقتصادي أخضر من فيروس كورونا، سوف تحتاج الحكومات إلى تحديد واتباع سياسات واضحة بشأن هذه القضية، قد تلعب فيها ضريبة الكربون دورًا جوهريا، وبخاصة فرض ضرائب مرتفعة على استخدام الوقود الملوث للبيئة. وبيت القصيد هنا أن نعطي الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري (بما في ذلك الغاز الطبيعي)، وبالتالي التحول نحو الاقتصاد اللاكربوني.
وما يبعث على بعض التفاؤل، أن عددًا متزايدًا من البلدان والشركات الخاصة تعهد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر. وفقط عندما تقترب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصفر، ستؤدي العملية الطبيعية المتمثلة في امتصاص الغاز في النظم الإيكولوجية مثل البحار والغابات- ستؤدي إلى تقليل تركيزه في الغلاف الجوي. بل حتى في هذه الحالة، سيبقى معظم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمئات السنين، وسيستمر في تسخين الكرة الأرضية. لذا، فإن الحد من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن سيمنع المزيد من التراكم الغازي في الغلاف الجوي، وبالتالي الانحراف إلى ما فوق الحد الذي تم تثبيته في اتفاقية باريس للمناخ.
على المدى الطويل، ستنتصر الطاقة المتجددة. فمنذ عامين، سعر الكهرباء الناتجة من طاقة الشمس أو الرياح تميز بكونه أرخص بكثير من سعر الغاز أو الفحم. وخلال العقد القادم، سيتطور مجال تخزين الطاقة، وعندئذ، سوف ننتقل بسرعة كبيرة إلى عالم قادر على فك ارتباطه بالطاقة القائمة على الوقود الأحفوري. نَعم أزمة كورونا تسببت في تأخير عملية التطور، لكن في النهاية، سيكون للاقتصاد الكلمة الفصل.
في الواقع، ستؤدي أزمة كورونا، إلى تسريع النمو في مجال الطاقة الشمسية؛ علما أن الطاقة الشمسية تعد جزءًا من خطط "النمو" للاقتصادات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، جائحة كورونا علمت العالم مدى واقعية وخطورة حدوث أزمة عالمية. إنها إذن مسألة وقت؛ فأزمة المناخ ستعود لتصبح القضية الرئيسية على جدول الأعمال العالمي، وبالتالي، الطاقة الشمسية هي الخيار الرئيسي للتخلص من الوقود الأحفوري.
وحالياً، يمر العالم، وبخاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بعملية تحول استراتيجي نحو سوق الكهرباء القائمة على الطاقات المتجددة. العديد من دول العالم آخذة بالتحول من الاقتصاديات الملوثة المعتمدة على الوقود الأحفوري، نحو الطاقات النظيفة.
أهداف إسرائيلية متدنية غير منجزة
قررت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر الماضي زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بمقدار 13% حتى عام 2030. وقد أقرت الحكومة مقترح مشروع قدمته وزارة الطاقة الإسرائيلية لزيادة حصة الطاقات المتجددة من 17% إلى 30%. باقي احتياجات الطاقة الإسرائيلية (70%) ستُغطّى من الغاز الطبيعي؛ علمًا أن (إسرائيل) اكتشفت منذ نحو عشر سنوات احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، قبالة الساحل الفلسطيني في البحر الأبيض المتوسط.
ومن المعروف أن الغاز الطبيعي ومنشآته يُعدان من المصادر الملوثة جدًا للبنية المناخية والإيكولوجية. وهنا يجب أن نتذكر بأنه في جميع مراحل دورة حياة استخدام الغاز الطبيعي تنبعث كميات كبيرة من غازات الدفيئة.
شركات النفط والغاز تزعم بأن توليد الطاقة بكافة أشكالها من الغاز الطبيعي تحديدا أقل ضررًا من النفط والفحم. إلا أن المعطيات العلمية تفنّد هذا الزعم وتؤكد بأن الغاز الطبيعي ضار جدًا للمناخ ولصحة الناس؛ فأثناء عملية استخراج الغاز ومعالجته، ومن ثم نقله، تنبعث كميات غاز الميثان أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا. هذه الانبعاثات تحوي مواد عضوية متطايرة، تأكد بأن بعضها مسرطن.
والحقيقة أن معدل كفاءة الطاقة في (إسرائيل) خلال عام 2020 كان أقل من نصف الهدف المعلن (حسب تقرير "مراقب الدولة الإسرائيلي")؛ علماً أن الهدف الإسرائيلي متوسط المدى حتى سنة 2020 كان إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة (وبخاصة من الطاقة الشمسية) بنسبة 10% من إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء في (إسرائيل).
كما أن "إسرائيل" لم تحقق الأهداف المعلنة بتحويل 20% من حركة المرور الخاصة نحو المواصلات العامة، بهدف تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الأهداف التي حددتها "إسرائيل" في إطار اتفاقية باريس للمناخ (عام 2015) تعد متدنية بالمقارنة مع سائر دول OECD، ورغم ذلك لم يتم إنجازها؛ سواء في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو في مجالات كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقات المتجددة أو التحول نحو المواصلات العامة.
والحقيقة أن حلولاً كثيرة للتغير المناخي والاحتياجات المتزايدة للطاقة المتجددة لا تزال حبيسة المختبرات الإسرائيلية، بما في ذلك العديد من الشركات والمجموعات البحثية التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة؛ مثل المعهد التكنولوجي الإسرائيلي في حيفا "التخنيون"، ومجموعة H2 Energy Now التي تقدم حلولاً لتخزين الطاقات المتجددة، وEnergiaGlobal المتخصصة بالمشاريع الشمسية، وJuganu التي طورت إضاءة "لِد" (LED) الذكية.
الفلسطينيون أكثر عرضة لآثار التغير المناخي
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مجرد جانب واحد من الحراك العالمي. لكن يجب أن نتذكر بأن منطقتنا، وفلسطين تحديداً، تقع على ساحل البحر بين المناخين المتوسطي والصحراوي، ما يزيد من حساسية منطقتنا وانكشافها للتغيرات المناخية، في مستويات مختلفة. فقد نشهد قريبًا حرائق ضخمة، كما في أستراليا؛ بالإضافة إلى أمواج تسونامي تأتينا من الغرب أو فيضانات مدمرة، وقد يرتفع أيضًا مستوى البحر.
ورغم أن آثار التغير المناخي في مختلف أنحاء بلاد الشام متشابهة إلى حد كبير، إلا أن الفلسطينيين تحديدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر حساسية وعرضة لآثار التغير المناخي بسبب واقع الاحتلال الاستيطاني. فالاحتلال يعد أكبر مهدد للتوازن الإيكولوجي والمناخي في فلسطين، كما يتجلى ذلك في النشاطات العسكرية العدوانية الضخمة المتسببة في كم هائل من الانبعاثات، وفي الجدار الكولونياليالعنصري، ونهب الأراضي والموارد الطبيعية والمياه والتوسع الاستيطاني المتواصل؛ وبالتالي الافتقار الفلسطيني للسيادة السياسية والوطنية على الأرض والموارد والمياه والغذاء، ما يجعل الفلسطينيين أكثر انكشافًا للتقلبات المناخية.
وللمقارنة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الإسرائيلي تُعد من الأعلى عالميا، إذ تبلغ نحو 11 طناً سنويا للفرد (صحيفة هآرتس، 20/9/2018)، بينما انبعاثات الفرد الفلسطيني لا تتجاوز 0.5 طن سنويا؛ أي أن متوسط انبعاثات الفرد الإسرائيلي تعادل 22 ضعف انبعاثات الفرد الفلسطيني؛ بل هي أكبر من معظم الدول الأوروبية حيث المواصلات العامة والحفاظ على الطاقة أكثر تطورًا من (إسرائيل). ولدى مقارنة واقع انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن فلسطينيي الضفة والقطاع بالانبعاثات العالمية أو الإسرائيلية، فسنجدها هامشية؛ إذ أن نسبة الانبعاثات الفلسطينية (الضفة والقطاع) تساوي 0.01% من إجمالي الانبعاثات العالمية (سلطة جودة البيئة، 2016. البلاغ الوطني الأول المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ)، وهذه النسبة لا تتجاوز انبعاثات مصنع عسكري إسرائيلي ضخم.
يضاف إلى ذلك هشاشة وعجز الحكم الذاتي الفلسطيني الذي لا يتمتع بإرادة سياسية مستقلة تمكنه من العمل باتجاه تخفيف المخاطر المناخية. ورغم ذلك، صاغت السلطة الفلسطينية خططا للسياسات البيئية، كان أبرزها عام 2016، وقد ورد فيها بأن السلطة ستخصص 3.5 مليار دولار لخطط التكيف مع التغير المناخي خلال السنوات العشر القادمة. ولم تتضمن الخطط مؤشرات لكيفية الحصول على هذه الأموال!
خلاصة القول، ما لم يتمتع الفلسطينيون بالسيادة السياسية والوطنية على أراضيهم ومواردهم الطبيعية والمائية، فلن يتمكنوا من التكيف الفعال مع التغير المناخي، وبالتالي ستبقى مخاطر انعدام السيادةالغذائية والمائية تحدق بهم.
وفي المقابل، على المستوى العالمي، ما يبعث على التفاؤل أن 50 دولة في العالم التزمت بأن تتحول نحو الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وذلك قبل الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة. لذا، يفترض بمنطقتنا العربية التي تتمتع بالإشعاع الشمسي الهائل معظم أيام السنة، أن ترفع سقف أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، وذلك على ضوء الأزمة المناخية والتحولات العالمية في سوق الطاقة.
ومن الواضح، أن الاقتصاد المستقبلي للطاقة لن يكون مركزيا أو احتكاريا، كما هو الحال في المستوى الفلسطيني، بل موزعا وقائما على أساس شبكات منطقية أو بلدية صغيرة. لذا، فإن الخطط والسياسات الحكومية القائمة على إنشاء شبكة محطات طاقة خاصة تعتمد على الغاز الطبيعي، تتعارض مع الاتجاهات الاقتصادية القائمة حاليًا في سوق الطاقة، وتُحَمِّل المواطنين مخاطر اقتصادية عالية، ولا تنسجم مع التعهدات الفلسطينية الدولية في مجال التغير المناخي.
بقي أن نقول، بأن تطوير منشآت الطاقة المتجددة توفر من 60 إلى 80 فرصة عمل لكل 50 ميغاواط يتم إنتاجها. أي أن عددًا كبيرًا من فرص العمل ستتوفر في حال بناء منشآت لإنتاج آلاف الميجاوات.
وفي مجال قطاع النقل، يمكننا التوسع في استخدام وسائل النقل العام من خلال تخصيص المزيد من المسارب في الطرق الحالية لهذا الغرض، وكذلك استخدام وسائل أخرى مثل "رسوم الازدحام" عند مداخل المدينة، فضلًا عن تقليص أماكن وقوف السيارات وتخصيصها للمشاة وراكبي الدراجات.
يضاف إلى ذلك ضرائب المركبات؛ والمقصود، بين أمور أخرى، إلغاء المزايا الضريبية لمركبات الديزل وفرض ضريبة شراء المركبات وفقًا لمستوى التلوث، ناهيك عن استبدال ضريبة الوقود بالضرائب وفقًا لمسافات القيادة.


